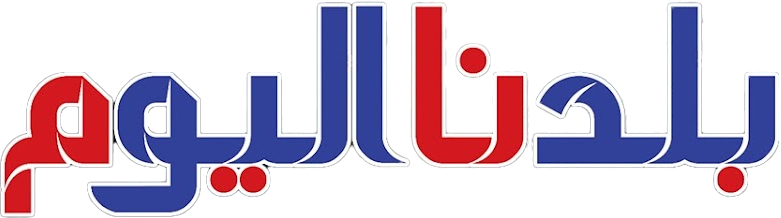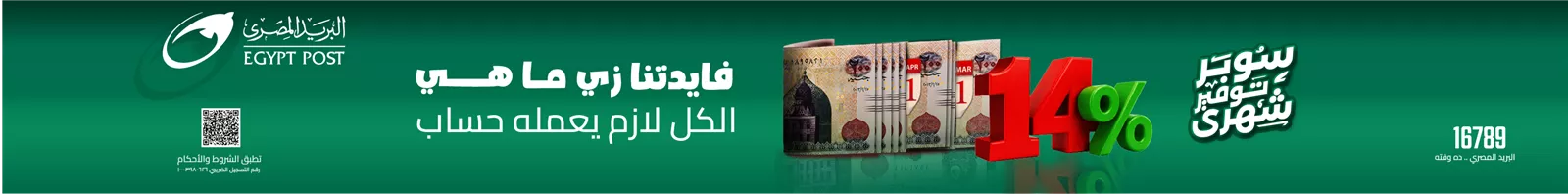سماء سليمان تكتب .. رؤي القوى الكبرى لمستقبل وطبيعة النظام الدولي

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحوّلاً عميقاً في بنية النظام الدولي، إذ لم تعد العلاقات بين الدول تُدار وفق منطق الهيمنة الأحادية الذي ساد بعد نهاية الحرب الباردة، بل تتجه نحو تعددية في مراكز القوة وتنوّع في الرؤى حول مستقبل هذا النظام. فالقوى الكبرى لم تعد تتقاسم تصوراً واحداً للعالم، بل لكلٍّ منها مشروعه الفكري الذي يعكس مصالحه الوطنية ورؤيته لمكانته في المرحلة المقبلة.
في الصين، يبرز فكر الرئيس شي جين بينغ الذي يدعو إلى بناء «مجتمع مصيرٍ مشترك للبشرية»، وهو تصور يقوم على التعاون واحترام السيادة ورفض منطق الهيمنة. ويعدّ المفكر يان شيوي تونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تسينغ-هوا، من أبرز المتخصصين في الدراسات المستقبلية الصينية؛ إذ يرى أن النظام الدولي يتجه إلى تعددية أقطاب حقيقية تشارك فيها الدول النامية والكبرى على السواء. في نظريته «الواقعية الأخلاقية» يؤكد أن القوة المادية وحدها لا تكفي لتأسيس نظام مستقر، بل لا بد من شرعية أخلاقية وسياسية. أما جيانغ شي غونغ فيعيد قراءة التاريخ الصيني ليدعو إلى نموذج حضاري بديل للنظام الغربي، يرى فيه الصين مركزاً للتوازن العالمي لا أداة للهيمنة.
أما الولايات المتحدة فتنظر إلى المستقبل من زاويتين متباينتين. فالمفكر جوزيف ناي يرى أن عصر الهيمنة الأميركية المطلقة انتهى، وأن على واشنطن أن تعتمد «القوة الذكية» التي تمزج بين التحالفات والدبلوماسية والتكنولوجيا. في المقابل، يؤكد المنظّر الواقعي جون ميرشايمر أن التعددية المقبلة ستقود حتماً إلى صراع بين القوى الكبرى، خصوصاً بين أميركا والصين. ويضيف المفكر البنيوي ألكسندر ويندت أن التحول المقبل لن يقتصر على ميزان القوى، بل سيمس الهويات والقيم التي تشكّل سلوك الدول، فالنظام القادم سيتحدد بقدر ما تتغيّر الأفكار داخل المجتمعات الكبرى.
وفي روسيا، يقوم التفكير المستقبلي على رؤية «الأوراسية الجديدة» التي صاغها ألكسندر دوغين، وهي تدعو إلى نظام متعدد الأقطاب يقوم على توازن حضاري بين الكتل الكبرى واحترام الخصوصيات الثقافية والسياسية. وتستند هذه الرؤية إلى «عقيدة بريماكوف» التي طرحت منذ التسعينيات فكرة قيام نظام متوازن بين روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند. وتنظر موسكو إلى التعددية ليس فقط كمطلب سياسي بل كمبدأ حضاري يضمن لها موقعاً مساوياً للغرب.
أما في أوروبا، فتتباين الرؤى بين المدرسة الفرنسية ذات الطابع الفلسفي والمدرسة الألمانية ذات النزعة المؤسسية. المفكر الفرنسي برتران بادي يرى أن النظام الدولي بعد 1945 لم يحقق سلاماً حقيقياً لأنه كرّس عدم المساواة بين الشمال والجنوب، ويدعو إلى نظام إنساني يقوم على العدالة والتضامن. وفي ألمانيا يبرز أوليفر شتوينكل، أحد المتخصصين في الدراسات المستقبلية للعلاقات الدولية، الذي يؤكد أن العالم يتجه نحو «نظام ما بعد الغرب»، وأن على أوروبا أن تتحول من تابعٍ للولايات المتحدة إلى قوة مستقلة تمتلك «استقلالاً استراتيجياً» في قراراتها.
وعند مقارنة هذه الرؤى، يتضح أن القوى الكبرى تتفق على أن الأحادية الأميركية في طريقها إلى الزوال، لكنها تختلف في تصور ملامح النظام الجديد. فالصين وروسيا تعتبران التعددية فرصة لإصلاح اختلالات الماضي، بينما ترى الولايات المتحدة وأوروبا فيها تحدياً يتطلب تحديث أدوات القيادة الغربية. كما تتفق جميع الأطراف على أن عناصر القوة في القرن الحادي والعشرين لن تقتصر على السلاح والاقتصاد، بل ستشمل التكنولوجيا والابتكار والمعرفة والتحالفات العابرِة للأقاليم.
إن الاتجاه العام يوحي بأن النظام الدولي المقبل سيكون أكثر تشابكاً وتداخلاً، تجمعه شبكة من المصالح المتبادلة رغم استمرار المنافسة. وسيظل الحوار بين القوى الكبرى حول القواعد الجديدة للعالم أحد أهم ملامح العقود القادمة. فبينما تسعى الصين إلى ترسيخ نموذجها التشاركي، وتعمل روسيا على فرض تعددية حضارية، وتعيد الولايات المتحدة صياغة دورها في عالم متغير، تبحث أوروبا عن موقعٍ يحافظ على قيمها ويمنحها استقلال القرار. وهكذا يبدو أن النظام الدولي القادم لن يكون أحاديّاً ولا فوضوياً، بل نظاماً متجدداً يعكس انتقال التاريخ من هيمنة الغرب إلى عالمٍ متعدد الأقطاب، أكثر تنوعاً وتوازناً وعدلاً.