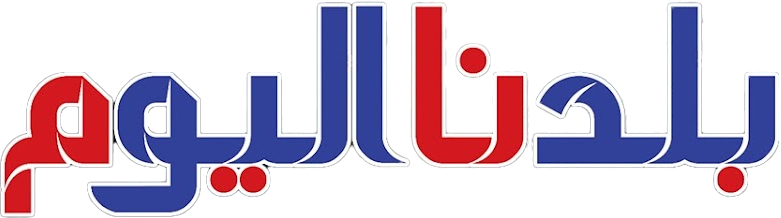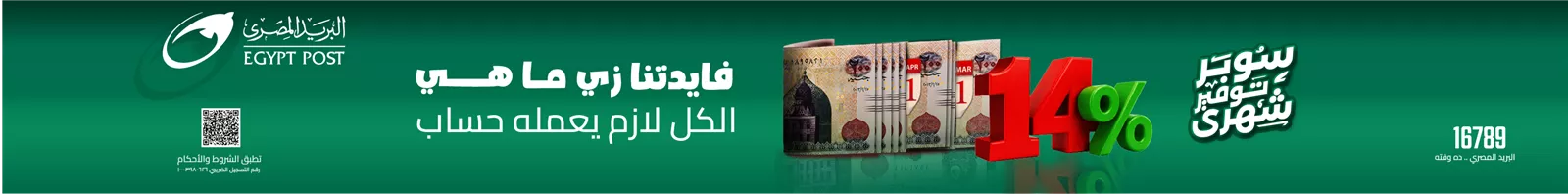محمود أبو بكر لـ"بلدنا اليوم": اتفاق رواندا والكونغو خطوة نحو السلام

في وقتٍ تشهد فيه منطقة البحيرات الكبرى تصاعدًا في التوترات السياسية والعسكرية، توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى اتفاق برعاية أمريكية ووساطة قطرية، يهدف إلى وضع حد للنزاع المزمن بينهما. في هذا الحوار، يحدثنا المدير العام للمركز الأفريقي لحقوق الانسان البروفسير محمود أبوبكر عن الخلفيات التاريخية للصراع، وأبعاده السياسية والاقتصادية، وفرص نجاح الاتفاق، ودور الأطراف الدولية فيه، وفيما يلي نص الحوار:
بدايةً، ما هي الخلفية التاريخية للصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية؟
الخلفية تعود إلى عام 1994، عندما اندلعت إبادة جماعية مروّعة في رواندا بين قبيلتي التوتسي والهوتو، وأسفرت عن مقتل أكثر من مليون شخص. عقب المجازر، لجأ عشرات الآلاف من مقاتلي الهوتو، ومعهم مدنيون، إلى شرق الكونغو (زائير آنذاك)، وأسسوا جماعات مسلحة من هناك بدأت بشن عمليات ضد الحكومة الرواندية الجديدة بقيادة بول كاغامي.
منذ ذلك الحين، تحوّل شرق الكونغو إلى ساحة مفتوحة لصراع بالوكالة، إذ ترى رواندا أن وجود هذه الجماعات المسلحة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، في حين تتهم الكونغو جارتها بدعم حركات تمرد مثل "حركة 23 مارس" بهدف زعزعة استقرارها والاستفادة من مواردها.
كيف لعبت الحركات المسلحة دورًا في تعقيد المشهد الأمني؟
الحركات المسلحة كانت ولا تزال أداة رئيسية في هذا الصراع. فـ"حركة 23 مارس"، على سبيل المثال، تضم مقاتلين من التوتسي، وتحظى بدعم غير مباشر من رواندا، وقد تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة في إقليم كيفو الشرقي. وكان هذا التقدم العسكري يهدد بالوصول إلى العاصمة كينشاسا، لولا التدخلات الدولية التي دفعت نحو تهدئة مؤقتة.
من جهة أخرى، هناك جماعات مثل "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وهي مكوّنة أساسًا من مقاتلين من الهوتو الروانديين، وتُتهم بتورطها في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الكونغوليين. هذا التداخل في الولاءات والانتماءات جعل من شرق الكونغو بؤرة نزاع دائم.
ما الأسباب العميقة لاستمرار النزاع حتى اليوم؟ وهل يقتصر الأمر على الانتماءات العرقية؟
الصراع أبعد من كونه عرقيًا أو قبليًا، وإن كانت هذه العناصر تُستخدم كوقود دائم لتأجيجه. هناك أسباب جذرية مرتبطة بالموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الكونغو، مثل الذهب والكولتان والماس. هذه الموارد تمثل مطمعًا ليس فقط للدول المجاورة، بل أيضًا لشركات دولية كبرى ودول عظمى تبحث عن النفوذ الاقتصادي في إفريقيا.
إلى جانب ذلك، تدعم كل دولة حركات معارضة للدولة الأخرى، ما يجعل الصراع يدور في دائرة مغلقة من الانتقام المتبادل والضرب تحت الطاولة. كذلك، ضعف الدولة المركزية في الكونغو، وغياب البنية الأمنية الفعّالة، يفتح المجال أمام الميليشيات لتنتشر وتستولي على الأرض والثروات.
الاتفاق الأخير بين الكونغو ورواندا، هل يمكن اعتباره تحولاً حقيقيًا؟
أراه خطوة إيجابية ومهمة، لكن لا يمكن اعتبارها تحولًا حقيقيًا ما لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض. الاتفاق يمثل على الأقل فرصة لوقف نزيف الدماء وتخفيف حدة النزوح واللجوء الذي يعاني منه الملايين. وتشير التقديرات إلى أن النزاع خلّف نحو 6 ملايين قتيل ونازح ولاجئ على مدى السنوات الماضية، وهو رقم يفوق ما خلفته بعض الحروب العالمية.
الاتفاق يُعتبر بمثابة هدنة أكثر من كونه تسوية نهائية، وقد أتى بعد ضغوط أمريكية ووساطة قطرية ناجحة، لكن نجاحه سيتوقف على إرادة الطرفين واستعدادهما الحقيقي لتقديم تنازلات.
ما هي الشروط المطلوبة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق؟
أولاً، ينبغي أن تكون هناك إرادة سياسية جادة من الطرفين، وليس مجرد توقيع على الورق. ثانيًا، على الجهات الراعية، وخصوصًا الولايات المتحدة وقطر، أن تواصل دورها الرقابي، لا كوسطاء محايدين فقط، بل كضامنين عمليين لأي التزام.
يجب أيضًا تفعيل آلية مراقبة محايدة، ربما عبر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، للتأكد من وقف الدعم العسكري للحركات المتمردة من كلا الجانبين، وضمان احترام الحدود السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. دون هذه الضمانات، سيبقى الاتفاق معرضًا للانهيار.
برأيك، كيف تؤثر المصالح الدولية في تعقيد المشهد؟
التأثير كبير وحاسم. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تدرك أن الكونغو تملك أحد أكبر احتياطيات العالم من المعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم، الضروريين لصناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة. لذلك، فإن أي استقرار في الكونغو سيُتيح للشركات الأمريكية الاستثمار دون عراقيل، وهو ما يفسر دعم واشنطن لهذا الاتفاق.
كذلك، هناك تنافس حاد مع الصين، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا قويًا للكونغو، وتسعى للهيمنة على مواردها الطبيعية. فرنسا أيضًا لديها مصالح تاريخية في إفريقيا الوسطى. هذا التنافس يجعل من النزاع بين الكونغو ورواندا ساحة حرب باردة جديدة، بواجهة أفريقية وعمق دولي.
هل ترى في الاتفاق بصيص أمل للشعوب المتضررة من النزاع؟
رغم التحفظات، نعم. الشعبان الرواندي والكونغولي عانيا كثيرًا من الحروب، والنزوح، وغياب التنمية. الاتفاق قد لا يكون حلاً سحريًا، لكنه على الأقل يعطي فرصة للشعوب كي تلتقط أنفاسها، ولبدء عمليات إعادة الإعمار.
لدينا نموذج رواندا، التي خرجت من جحيم الإبادة، واستطاعت أن تبني تجربة تنموية ناجحة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والحوكمة. نأمل أن تنجح الكونغو أيضًا في السير نحو الاستقرار، وهذا لن يتحقق إلا بوقف الحرب وفرض سيادة القانون.
كيف تتوقع مستقبل المنطقة في ظل هذا الاتفاق؟
منطقة البحيرات الكبرى لن تهدأ ما لم تُحل النزاعات من جذورها، وما لم تُفكك الشبكات المسلحة وتُفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي. الاتفاق الأخير يمكن أن يكون حجر أساس لهذه المرحلة، لكنه يحتاج إلى إرادة صلبة ومتابعة حثيثة.
كما يجب على المجتمع الدولي ألا ينظر لإفريقيا كمصدر للثروات فقط، بل كشريك حقيقي في التنمية. وإن فشل هذا الاتفاق، فإننا سنشهد موجة جديدة من التهجير والاقتتال. أما إن صمد، فربما يكون بداية تحول تاريخي.