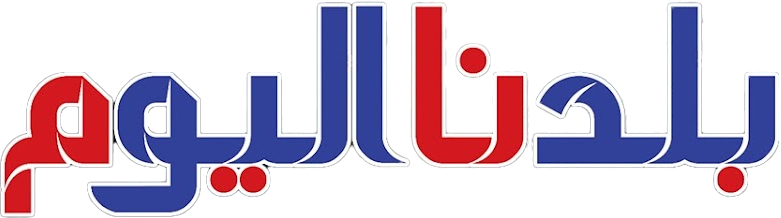د. أميرة شوقي تكتب: الاستقطاب السياسي أزمة أفكار أم أزمة نفسية؟

هل نحن مختلفون سياسيًا، أم أننا أصبحنا غير قادرين نفسيًا على تحمّل الاختلاف؟، هذا السؤال يفرض نفسه بقوة في زمن لم يعد فيه الخلاف السياسي نقاشًا حول أفكار أو برامج، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى حالة من التوتر والعداء الشخصي، المختلف لم يعد مجرد صاحب رأي آخر، بل صار يُنظر إليه كتهديد، أو كطرف لا يمكن الوثوق به.
من هنا، يبدو أن الاستقطاب السياسي لم يعد أزمة أفكار فقط، بل أزمة أعمق تمس طريقة تفكيرنا، وشعورنا بالأمان، وقدرتنا على التعايش مع من لا يشبهنا، وهي منطقة يلتقي فيها السياسي بالنفسي، ويصبح علم النفس السياسي أداة ضرورية للفهم..ماذا يحدث ولماذا تحولنا من منطقة اختلاف الرأي إلى منطقة صراع الهويات..؟
في المجتمعات المستقرة، يكون الرأي السياسي موقفًا قابلًا للنقاش والتغيير، لكن في أوقات القلق والضغوط، يتحول الرأي تدريجيًا إلى هوية. لا يعود السؤال: ماذا أرى؟ بل: من أنا؟ ومن يقف ضدي؟
وتشرح نظرية الهوية الاجتماعية كيف يميل الأفراد إلى تعريف أنفسهم من خلال الجماعات التي ينتمون إليها، ومع هذا التعريف يأتي تلقائيًا تقسيم العالم إلى “نحن” و“هم”. ومع الوقت، تُنسب الفضائل إلى الجماعة التي ننتمي إليها، بينما تُسقط النوايا السيئة على الجماعة الأخرى، وهنا لا يعود الخلاف سياسيًا فقط، بل نفسيًا، لأن أي نقد للفكرة يُستقبل كنقد للذات نفسها.
نعم الخطر يكمن حين لا يبحث العقل عن الحقيقة
قد يبدو للوهلة الأولى أن الاستقطاب ناتج عن نقص في المعلومات، لكن علم النفس يشير إلى العكس: المشكلة ليست في قلة المعلومات، بل في طريقة التعامل معها. فالعقل البشري لا يعمل كقاضٍ محايد، بل كمحامٍ يدافع عن القناعات التي تمنحه الشعور بالطمأنينة.
هذا ما يُعرف بـ (التحيز التأكيدي) : الميل إلى تصديق كل ما يدعم موقفنا، والتشكيك في كل ما يناقضه. في السياق السياسي، يتحول هذا التحيز إلى أداة دفاع نفسي، تبرر أخطاء “جماعتنا”، وتضخم أخطاء “الآخرين”، حتى لو كانت متشابهة، ومع تكرار هذا النمط، لا يعيش الأفراد داخل واقع واحد، بل داخل روايات نفسية متوازية، لكل منها “حقائقها” الخاصة، وهنا نطرح سؤالا تأمليا .. كيف تحول الأمر من الانحياز الفردي إلى الاستقطاب الجماعي..؟!
ما كان يمكن أن يظل انحيازًا فرديًا، تحوّل بفعل وسائل التواصل الاجتماعي إلى حالة جماعية واسعة. فهذه المنصات لا تفرض علينا آراء بعينها، لكنها تعزز ما نميل إليه بالفعل، وتعيد عرضه علينا باستمرار.
مع الوقت، يجد الفرد نفسه داخل دائرة مغلقة من الآراء المتشابهة، حيث يتحول الاتفاق إلى تطبيع، والاختلاف إلى صدمة. وهكذا تتشكل “غرف الصدى”، التي لا يسمع فيها الإنسان إلا صوته، ويزداد اقتناعه بأن الطرف الآخر إما جاهل أو سيئ النية.
في هذا المناخ، يصبح الحوار عبئًا نفسيًا، لا فرصة للفهم.
إذن نحن على أعتاب فهم لماذا تنجح الخطابات المتطرفة؟
ففي أجواء الاستقطاب، لا يزدهر الخطاب الأكثر عقلانية، بل الأكثر بساطة. الخطاب المتطرف يقدّم إجابات سهلة لأسئلة معقدة، ويعرض العالم في صورة ثنائية مريحة: خير مطلق في مقابل شر مطلق.
وهنا علم النفس يوضح أن البشر، حين يشعرون بفقدان السيطرة أو الغموض، يميلون إلى الخطابات التي تمنحهم يقينًا سريعًا، حتى لو كان هذا اليقين قائمًا على تبسيط مخل أو تضليل. وهكذا لا يكون الانجذاب للتطرف دليل وعي سياسي، بل استجابة نفسية للقلق والخوف، ويبقى السؤال : ماذا يحدث حين تتحول السياسة إلى كراهية..؟
حيث الخطر الحقيقي للاستقطاب لا يكمن في الخلاف ذاته، بل في نزع الإنسانية عن المختلف. عندما يُختزل الطرف الآخر في صورة نمطية سلبية، يصبح تجاهله أو إقصاؤه أو حتى كراهيته أمرًا مبررًا نفسيًا.
ان التاريخ يبيّن أن أكثر اللحظات السياسية خطورة هي تلك التي يتوقف فيها الناس عن رؤية خصومهم كمواطنين، ويرونهم فقط كتهديد يجب تحييده.
فهل نحن حقا أمام أزمة أفكار أم أزمة نفسية؟
ربما يكون الجواب: الاثنتان معًا. فالأفكار لا تنتشر في فراغ، بل عبر عقول مثقلة بالقلق، وهويات تبحث عن الأمان، ونفوس تخشى فقدان المعنى. لذلك، لا يمكن التعامل مع الاستقطاب السياسي فقط عبر القوانين أو الخطابات، دون فهم البعد النفسي الذي يغذيه.
وأخيرا وليس آخرا
في المجتمع المصري، لا يظهر الاستقطاب دائمًا في صورة صدامات سياسية مباشرة، لكنه يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية: في النقاشات العائلية، وفي مواقع التواصل، وفي المسافة المتزايدة بين الصمت والاتهام. كثيرون لم يعودوا يناقشون السياسة، لا لأنهم غير مهتمين، بل لأن التجربة أصبحت نفسيًا مُرهقة، ومشحونة بالخوف وسوء الفهم.
علم النفس السياسي يوضح أن هذه الحالة ليست دليلًا على اللامبالاة، بل على *إجهاد نفسي جماعي*، حيث يشعر الفرد أن أي رأي قد يُساء تفسيره، وأن الاختلاف لم يعد آمنًا كما كان. ومع الوقت، يتحول الصمت إلى آلية دفاع، ويتحول الشك إلى حذر دائم من الآخر.
ربما لا تحتاج السياسة في مصر اليوم إلى مزيد من الأصوات المرتفعة، بقدر ما تحتاج إلى استعادة المساحة النفسية التي تسمح بالاختلاف دون خوف، وبالنقاش دون تصنيف. فقبل أن تكون أزمة سياسات، تبدو الأزمة — في جوهرها — أزمة ثقة، وأزمة شعور بالأمان في التعبير، وهي أمور لا تُحل بالقوانين وحدها، بل بفهم أعمق لطبيعة الإنسان حين يُدفع إلى الزاوية والتهميش.